كاتب سرياني من القرن الثالث الميلادي
بقلم/ أشرف عبد المحسن مندور
باحث دكتوراه
ظهرت في خواتيم القرن الثالث الميلادي ديانة وضعيه سميت بالمانوية نسبة إلى واضعها ماني، وقد حسبها البعض من المؤرخين على أنها فرقة غنوصية نظرا لبنيتها التركيبية القائمة على الثنائية في الكون بين الخير والشر من ناحية، أو في مسألة الأصل الإلهي للروح والطبيعة المادية للجسد من ناحية أخرى، وكذلك للتشابه الواضح معها كذلك في تعقيداتها الغير متناهية.
أما فيما يخص الحديث عن التأريخ لسيرة ماني (ܡܐܢܝ) (216-277م) مُنشئ تلك البدعة، فهو الفنان ورسام الكاريكاتير والمفكر والمبتدع، أو كما قال عنه مريديه، مُعلم القرن الثالث الميلادي، الرجل المقدس، السيد ماني، رسول النور، وروح الحق، وكذلك كما قال عنه معارضوه، هو ذلك الرجل المهووس، والهرطوقي، والشرير، والآثم.
فكان الأمر المتوقع إذاً وفقاً لتضارب الآراء حوله أن تكون كثيرة هي تلك الروايات التي تتناول سيرته بالذكر من كلا الجانبين، ويمكن تقسيم تلك الروايات على هذا الأساس إلى نوعين:
النوع الأول الجبهة المعارضة:
نقصد بتلك الجبهة أصحاب الرواية الضدية وعلى الخصوص الرواية المسيحية، ثم من على شاكلتهم من معارضي المانوية، ولعل أقدم الصور لتلك الروايات هي تلك الرواية المعروفة باسم أعمال أرخيلاوس (Acts of Archelaus) ([1]) والتي يعود زمن كتابتها فيما بين سنتي 330 و340م. وهذا العمل كُتب في الأصل باللغة اليونانية، وفُقد ذلك الأصل، ولكنه حُفظ في ترجمات إلى لغات أخرى من بينها القبطية واللاتينية. ([2])
النوع الثاني الجبهة المؤيدة:
وهي تلك التي حاولت أن تأخذ الموضوع بنظرة متحيزة بقدر كبير، فتناولت سيرة ماني بشيء من الإيجابية المطلقة، فكانت هي الأخرى تتخللها بعض الأكاذيب المدسوسة. وكما يتبادر إلى الذهن فإن تلك الجبهة يندرج تحتها جميع الروايات التي كتبها مريدي ماني ومعتنقي ديانته، مع إضافة كذلك من نقل عنهم من المتأخرين من أمثال ابن النديم في كتابه الفهرست الذي كتبه في خواتيم القرن العاشر الميلادي ([3]).
على العموم فإن المتعارف عليه هو أن ماني بن بابك ولد في مدينة ماردين من أعمال بابل بالعراق سنة 216م، وكانت بابل وقتها تابعة للإمبراطورية الفارسية في عهد الأسرة الساسانية (224-651م). وقد اختلطت في مدينة بابل شتى الديانات والملل والطوائف كاليهودية، والمسيحية، والمندائية، والزرادشتية، وقد مثلت تلك الديانة الأخيرة الديانة الرسمية للإمبراطورية آنذاك. واجتمع كل ذلك الفيض الديني مع عدد من المدارس الفلسفية والفكرية كذلك ممثلاً في الجماعات الغنوصية بشتى فرقها والفلسفات الهلنستية العديدة كالأفلاطونية المحدثة والأبيقورية والرواقية وغيرهم. وقد عاش ماني إذا في خضم ذلك التنوع الديني والثقافي الكبير، واستفاد من جميع تلك الثقافات أيم استفادة حتى أن البعض من الباحثين أكد من أن الديانة المانوية التي أنشئها إنما هي ديانة توفيقية جمعت كل ما سبق في بوتقة واحدة. ([4])
وقد مرت طفولة ماني في سلام تام حتى وصل به العمر إلى العام الثاني عشر، فقال وقتها بأنه قد جاءه الوحي من لدن ملك جنان النور وفقاً لرواية ابن النديم، فترك كل ما سبق أن تعلمه، وبدأ يُصيغ معتقده الخاص به، ثم أنه لصغر سنه لم يستمر معه الوحي حتى بلغ من العمر الرابعة والعشرون، فأعلن علانية عن رسالته في سنة 240م في أواخر حكم الملك الساساني أردشير الأول (224-242م).
وكان مبتدأ دعوته أن قال: بأن كل ما سبق من ديانات وأفكار ومعتقدات ما هو إلا تحريف للديانة الأصلية التي نادى بها في السابق رسل من أمثال بوذا (Buddha) وزرادشت (Zarathustra) والمسيح وغيرهم، ثم أنه بعد وفاة هؤلاء تم تحريفها على يد أتباعهم الذين أخطئوا فهم مضامين الديانة على الوجه الصحيح. كما أن كل هؤلاء الرسل إنما كانوا مبعوثون إلى منطقة محددة من العالم، وكل واحد كانت له لغته الخاصة، وطريقته في تبليغ رسالته. واعتبر ماني نفسه هو الخاتم لهؤلاء الرسل، والمتمم لما بدأوه، والمصحح للمسار الذي انحرف من بعدهم. كما أنه ذكر أكثر من مرة من أنه هو الباراقليط – الْمُعَزِّي– (παράκλητος) ([5]) الذي بشر به السيد المسيح.
والمتأمل لبداية تلك الدعوة من ماني سيتبين أنها لم تلق الرواج الذي كان ينتظره، فكان أن قرر أن يجوب بلدان الشرق لعله يُصادف ما ينشده من نشر الدعوة في بيئة تكون صالحة لبذر بذورها فتينع وتزدهر بها.
وكانت من البلاد التي شد الرحال إليها بلاد الهند، واستطاع أن يُقنع أحد ملوك إحدى المقاطعات بها بترك الديانة البوذية التي يعتنقها وأن يتبنى مذهبه، ومنذ تلك اللحظة وبدأ ملوك الهند وغيرها من دول أسيا بتلقف تلك الدعوة الواحد بعد الأخر، وبما أن العامة تسير على دين ملوكهم؛ فكان أن بدأت دعوة ماني تُلاقي الانتشار الذي كان يبتغيه منها إلى حد فاق تصوره.
من الجدير بالذكر أن ماني بعدما استنزف طاقاته في بلدان الشرق العتيدة، عاد إلى بلاده سنة 242م على وجه التقريب، وتبعه في بابل الكثير من الأتباع حتى وصلت أنباء دعوته مسامع أروقة القصر الإمبراطوري على عهد ملكها شابور الأول (240-270م) -الذي اشترك مع والده أردشير الأول في أخر سنتين من حكمه، وظلا على تلك الشراكة حتى انفرد شابور بالحكم وحده بعد وفاة والده منذ سنة 242م، وهي تلك السنة التي وصل فيها ماني إلى بابل- فكان أن اعتنق المانوية عدد لا بأس به من حاشية الملك. وعلى الرغم من أن الملك نفسه لم يعتنقها إلا أنه غض الطرف عنها مدفوعا بمزاعم من أنها لا تتعارض مع الديانة الزرادشتية -الديانة الرسمية للدولة- لذا فلم يقف في طريق دعوة ماني، ولا حاول أن يحبطها أو يضطهدها.
لم يترك ماني تلك الحرية الفكرية المتاحة له دون أن يستغلها أفضل استغلال فكان أن ازدهرت المانوية أكثر في تلك الفترة من حكم شابور، وعمت جميع أرجاء إمبراطوريته، كما أنه وصلت أنباءها إلى الإسكندرية على يد أحد أتباعه والذي كان يُدعى هرميياس Ἑρμείας.
ظلت تلك هي الحالة فيما يخص ماني طوال فترة حكم شابور الأول الطويلة، واستمر ذلك بعد وفاة شابور ليخلفه هرمز الأول الذي لم يستمر حكمه سوى عام واحد.
اختلف الأمر تماما بعد وفاة هرمز الأول في حكم الملك بهرام الأول (271-276م)، الذي كان هو الويل الأعظم للمانوية، حيث اضطهدت المانوية في عهده، وأشاع الملك بهرام الأول الرعب في نفوس معتنقيها حتى انتهى الأمر بالقبض على ماني وإيداعه السجن. وظل ماني في السجن أياما معدودات عومل فيهم معاملة قاسية، وكان فيها مقيدا بالسلاسل؛ يعذب بهم حتى فاضت روحه. وصلبه الملك بهرام بعد ذلك على أحد أبواب مدينة جنديسابور سنة 276م ([6]).
ترك ماني وراءه عدد من المؤلفات التي تشرح عقيدته ومذهبه، وإن كان لم يبق منها سوى شذرات هنا وهناك، ومن الجدير بالذكر أن ماني خط بريشته كل كتاباته باللغة السريانية فيما عدا كتاب الشابوهراجان الذي كتبه باللغة الفارسية خصيصا للملك شابور الأول وإليه نُسب. وعلى الرغم من أن جل كتابات ماني فُقدت إلا أنه يمكن أن نخلص إلى محتوى عام لها كما يلي:
_إنجيل ماني ([7]):
هو عمل انتقائي في المقام الأول، كتبه ماني مستقياً مادته من بين روافد عديدة يقف على رأسها الأناجيل الأربعة القانونية المتعارف عليها (متى، لوقا، مرقس، يوحنا) مع إنجيل خامس، هو إنجيل دياتسرون (Τὸ διὰ τεσσάρον εὐαγγέλιον) ([8]). كما أنه استعان بالبعض من الأناجيل الأخرى الأبوكريفية (غير القانونية) مثل إنجيل فيليب وإنجيل طفولة المسيح، وإنجيل توماس.
_الإنجيل الحي (العظيم):
يعتبر هذا الإنجيل في حكم المفقود في أغلبه فيما عدا ثلاث شذرات. وقد ذكر البيروني أن ماني قسمه على هيئة اثنين وعشرون سفراً على عدد الحروف السريانية الشرقية، بحيث أن كل سفر معنون بحرف سرياني ([9])، فمثلاً أول سفر عنوانه أُولاف (ܐ)، والسفر الثاني بيث (ܒ)، والثالث جُومل (ܓ) وهكذا إلى أخر سفر بالإنجيل المعنون بحرف تاو (ܬ) أخر الحروف السريانية.
يقول ماني في مطلع واحدة من تلك الشذرات الثلاث الباقية: “أنا ماني رسول يسوع الصديق، في محبة الآب، الواحد المجيد” ([10])
_كتاب الصور:
لم يكتف ماني بشرح أفكاره ومعتقداته في مؤلفاته، وإنما أعتمد كذلك على الفنون؛ فكان يُكثر في أحايين كثيرة من بسط أفكاره على شكل رسومات وأشكال توضيحية لما سبق أن أوضحه بالكلمات؛ وذلك حتى يُتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المُتلقين وخاصة ممن ليس لهم دراية بالكتابة والقراءة، وقد وصلنا عدد لا بأس به من تلك الصور والأشكال التي صنفها أتباعه بعد ذلك فيما عرف باسم كتاب الصور الذي ضم بين جنباته معظمها ([11]).
_كنز الحياة:
لم يستدل على وجود ذلك العمل على الرغم من أنه يعتبر من الكتب المشهورة في التراث المانوي. فقد ذكره أوغسطينوس عدة مرات في كتبه، ووصلت شهرة هذا الكتاب على الأقل حتى القرن الحادي عشر الميلادي، إذ ورد ذكره لدى العالم العربي البيروني في مؤلفه الذي كتبه عن بلاد الهند (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) ([12]).
_سفر الأسرار:
إن هذا الكتاب كما يصفه بيرنز (Dylan M. Burns) أنه مصداقاً لاسمه فهو أكثر النصوص التي كتبها ماني غموضاً فلا نعرف عنه شيئا على الإطلاق سوى ما كتبه العلماء العرب عنه من أمثال البيروني وابن النديم ([13]). فيقول ابن النديم على سبيل المثال عنه أنه يتكون من ثمانية عشر فصلا ذاكراً عناوين تلك الفصول دون أن يشرح ما تتضمنه من ([14])، ولكن يمكن الاستناد من تلك العناوين إلى أنه كتبه في معظمه لمناقشة كتابات بارديصيان الغنوصي (154-223م) ([15])، فأول فصل من تلك الفصول خصصه ماني للحديث عن طائفة “الديصانيين” كما سماها ابن النديم؛ وهي طائفة مأخوذ اسمها من اسم ذلك الغنوصي. ومما يؤكد ما سبق أن أفرام السرياني ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ (306-373) ([16]) ذكر بأن بارديصيان كان له عملاً باسم الأسرار، وكما يلاحظ هو نفس الاسم الذي اختاره ماني كعنوان لكتابه ([17]).
_سفر الجبابرة أو العمالقة:
يُعد هذا الكتاب من أهم الكتب المانوية بما احتواه من عدد كبير من الأساطير والمرويات المجموعة على فترات، كما يتضح من ذلك العمل أنه كتاب مجموع من عدة مصادر وليس من تأليف ماني وحده. ويحوى سفر الجبابرة في معظمه على تأثيرات فارسية، كما يبدو كذلك تأثره بالكتاب الأبوكريفي الشهير كتاب أخنوخ ([18]).
_مزامير ماني:
يمكن القول عن هذه المزامير أنها كُتبت خصيصا لتتلى في الصلوات ولأداء الطقوس المانوية، وتلك المزامير أغلبها من تأليف ماني كتبها باللغة السريانية في لغة شعرية قلد فيها ماني مزامير العهد القديم. وقد اشترك واحد من تلاميذ ماني في تأليف البعض من تلك المزامير وهو الذي يُعرف باسم توما أو توماس، فله فيها مزامير تُعرف باسمه.
_رسائل ماني:
من المتعارف عليه أن ماني كتب أيضا عدداً كبيراً من الرسائل، الكثير منها موجز، فلا تخرج عن كونها إشارة تنبيهه لجماعة من نية ماني لزيارتهم، أو رسالة ترحيبية بوفد قادم، أو رسالة لشرح مسألة عقائدية معينة، وهكذا. وقد تولى أتباعه من بعده تجميع تلك الرسائل في مجموعات. وقد حفظ ابن النديم عناوين أكثر من ستة وسبعين رسالة من تلك الرسائل، فمنها على سبيل المثال رسالة الأصلين، رسالة الكبراء، رسالة هند العظيمة، رسالة قضاء العدل، رسالة عن البر، وغيرهم ([19]).
كما أنه بالتقادم في تاريخ المانوية، بدأت تظهر مؤلفات أخرى كثيرة غير ما سبق من تأليف أتباعه ومريديه، من أبرزها:
_البراغماتي أو الأساطير:
يتضح من خلال هذا العمل أن أقدم تاريخ لكتابته قد يعود للقرن التاسع الميلادي. وهذا الكتاب من الكتب المقروءة للغاية من قبل غير المانويين لما احتواه من سرد شائق وخلاب لأساطير الخلق وميلاد الآلهة وغير ذلك، وهو يتضمن الكثير من الاقتباسات عن كتب ماني السالفة الذكر ([20]).
_الكيفالايا: ([21])
هو عمل مكتوب باللغة القبطية، ومن الظاهر أنه مُترجم عن لغة أخرى غيرها لعلها السريانية، يظهر فيه ماني وكأنه معلم يتحدث مع تلاميذه، فيجيبهم على أسئلة طرحوها عليه، أو أنه يتولى إرشادهم بكلمات ملهمة، كما صور الكتاب تلاميذه كأنهم مثل حواري المسيح. ([22])
([1]) يُنسب هذا العمل إلى الأسقف هيجيمونيوس Hegemonius من القرن الرابع الميلادي، وقد كان أسقفاً على مدينة كارشار Carchar (حران بتركيا الحالية) وفقاً لما كتبه سقراطيس، وقد كتب ذلك العمل باللغة اليونانية على شكل مناظرة خيالية وقعت بين أرخيلاوس وبين ماني، وقد تُرجم العمل إلى اللغة اللاتينية، ثم فُقد الأصل اليوناني، ولم يتبق سوى الترجمة اللاتينية. وكذلك بعض الفقرات التي اقتبسها إبيفانيوس في كتابه ضد الهرطقات. للمزيد عن نشرات ذلك الكتاب انظر: S. D. F. Salmond (trans.), The Works of Gregory Thaumaturgus, Dionysius of Alexandria and Archelaus, (Edinburgh, 1870), 272-419; Charles H. Beeson (trans.), Acta Archelai (Leipzig, 1906), 1-100.ومن الدراسات الحديثة التي تناولت ذلك العمل، انظر الكتاب الذي قام بتحريره كل من جاسون بيدون وبول ميريكي، وهو كتاب جمع بين دفتيه احدى عشر دراسة مكثفة عن أعمال أرخيلاوس وحده: Jason David Beduhn and Paul Mirecki (ed.), Frontiers of Faith, The Christian Encounter with Manichaeism in the Acts of Archelaus, (Leiden, 2007).
([2]) في تلك الرواية يحكي كاتبها أن مُعلم عربي تزوج من امرأة من صعيد مصر، وكان لذلك التاجر تلميذ [يدعي الكاتب أنه هو الذي أصبح اسمه بوذا بعد ذلك] وأن هذا التلميذ كتب لأستاذه أربعة كتب هي الأسرار (Mysteries)، والفصول (Chapters)، والإنجيل (Gospel)، والكنز (Treasure)، ثم أن ذلك التاجر توفاه الله، فأخذ التلميذ حصيلة ما كتبه وانتقل للعيش في بابل، وهناك صادف سيدة عجوز عاش معها إلى أن مات هو الأخر تاركاً كل ما كتب معها. ثم أن تلك السيدة العجوز حصلت على طفل صغير يبلغ من العمر سبع سنوات وكان اسمه كوربيكوس (Corbicius) وكان عبداً، فحررته وعلمته القراءة والكتابة، وحين بلغ من العمر اثنا عشر سنة أصبحت تلك الكتب الأربعة في حوزته بعد وفاة السيدة العجوز، وبعد فترة من الزمن انتقل كوربيكوس إلى العاصمة الفارسية، وعاش فيها بعدما غير اسمه إلى ماني، وأنه عكف على دراسة تلك الكتب الأربعة السالفة الذكر حتى حفظها عن ظهر قلب ثم نسبها في فترة لاحقة إلى نفسه، وبدأ ينشر دعوته من لحظتها. وقد نقل سقراطيس تلك الرواية بحذافيرها عن أعمال أرخيلاوس عند حديثه عن ماني في تاريخه الكنسي.
([3]) فمن تلك الروايات الشهيرة قول ابن النديم في الفهرست نقلاً عن كتب مانوية مفقودة: “… مَانِي بن فتق بابك بن أبي برزام من الحسكانية، واسم أمه ميس ويقال أوتاخيم، ويقال مرمريم من ولد الأشغانية. وقيل إن ماني كان أسقف قُني والفِرياب [من أهل جُوخي وما يلي بَادارياَ وباكُسايا]، وكان أحنف الرجل، وقيل: إن أصل أبيه من همدان، انتقل إلى بابل وكان ينزل المدائن في الموضع الذي يسمى طيسفون، وبها بيت أصنام. وكان فتق يحضر كما يحضر سائر الناس، فلما كان في يوم من الأيام، هتف به من هيكل بيت الأصنام هاتف: يا فتق لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا تنكح بشرا، تكرر ذلك دفعات في ثلاثة أيام، فلما رأى فتق ذلك، لحق بقوم كانوا بنواحي دَسْتُمِيسَان معروفون بالمغتسلة، وبتيك النواحي والبطائح بقاياهم إلى وقتنا هذا، وكانوا على المذهب الذي أُمِر فتق بالدخول فيه، وكانت امرأته حامِلا بماني، فلما ولدته زعموا [أنها] كانت ترى له المنامات الحسنة، وكانت ترى في اليقظة كأن آخذا يأخذه فيصعد به إلى الجو ثم يرده، وربما أقام اليوم واليومين ثم يرد، ثم إن أباه أُبعِدَ فحمله إلى الموضع الذي كان فيه، فرُبى معه وعلى ملته. وكان يتكلم ماني على صغر سنه، بكلام الحكمة. فلما تم له اثنتا عشر سنة، أتاه الوحي، على قوله، من ملك جنان النور، وهو الله، تعالى عما يقوله، وكان الملك الذي جاءه بالحي يسمى التوم، وهو بالنبطية، ومعناه القرين، فقال له: “اعتزل هذه الملة فلست من أهلها، وعليك بالنزاهة وترك الشهوات، ولم يأن لك أن تظهر لحداثة سنك”. فلم تم له أربع وعشرون سنة، أتاه التوم، فقال: “قد حان لك أن تخرج، فتنادي بأمرك…” محمد بن إسحاق النديم، كتاب الفهرست مج2، تحقيق أيمن فؤاد سيد، (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 2009)، 378-380.
([4]) جيراردو غنولي، “ماني والمانوية”، ترجمة عبد الرزاق العلي، في كتاب موسوعة تاريخ الأديان الكتاب الخامس (الزرادشتية، المانوية، اليهودية، المسيحية) تحرير فراس السواح، (دمشق: دار التكوين، 2016)، 63.
([5]) “وَأَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ.” انظر: يو14: 26. انظر أيضا ابن النديم، الفهرست، 381.
([6]) Iain Gardner & Samuel N. C. Lieu (ed.), Manichaean Texts from The Roman Empire, (Cambridge, 2004), 85-95.
([7]) Duncan Greenlees (edit), The Gospel of the prophet Mani, (Madras, 2007), 1-293.
([8]) هو الإنجيل الذي عمل على تأليفه تاتيان السوري، عمد فيه إلى تنسيق فقرات من الأناجيل الأربعة معا ليؤلف منها رواية إنجيلية واحدة متواصلة لذلك أسماه تاتيان “الذي من خلال الأربعة دياتسرون”.
([9]) Michel Tardieu, Manichaeism, trans. M. B. DeBevoise, (Chicago, 1997), 35-36; Greenlees, The Gospel of the prophet Mani, Preface, clviii.
([10]) Greenlees, The Gospel of the prophet Mani, Preface, clix.
([11]) Tardieu, Manichaeism, 43-44.
([12]) Tardieu, Manichaeism, 37-38.
([13]) Dylan M. Burns, “Mani’s Book of Mysteries: A Treatise De anima”, Manichaeism and Early Christianity Selected Papers from the 2019 Pretoria Congress and Consultation, ed. Johannes van Oort, (Leiden, 2021), 70.
([14]) ابن النديم، الفهرست، 398-399.
([15]) لم يتبق من كتابات بارديصيان سوى عمل وحيد نُسب إليه بعنوان عن المصير أو كتاب قوانين البلدان، محفوظ في لغته السريانية، ولكن من الواضح أن الذي كتب هذا العمل هو واحد من تلاميذ بارديصيان. مدحه يوسابيوس واصفا إياه بأنه شخص قدير، وباحث لامع كتب مؤلفاته باللغة السريانية، وقد اضطلع تلاميذه بترجمتها من بعده إلى اللغة اليونانية.
([16]) يُعد أفرام السرياني المولود في مدينة نصيبين من أكبر وأهم الشعراء والكتاب السريان، اتخذ الرهبنة أسلوب حياة، ظل شماسا طوال حياته فلم يكن يرغب في أن يكون ذا منصب كهنوتي، وظلت سيرته عطرة لأجيال عديدة من بعده. انظر:Sidney H. Griffith, “Images of Ephraem: The Syrian Holy Man and His Church”, Traditio, Vol. 45, (1990), 7-8.
([17]) Tardieu, Manichaeism, 38.
([18]) هو كتاب أبوكريفي كُتب في الأصل باللغة الآرامية فيما بين سنتي 163و80 ق.م، وهو عبارة عن مجموعة من الأسفار اليهودية، ثم فُقد الأصل الآرامي، وبقيت أجزاء منه في ترجمات يونانية وحبشية. والكتاب ينقسم إلى خمسة أجزاء، وهو ملئ بمعلومات عن أسرار الكون والسماء والأقدار والأرواح والملائكة العالين وغير ذلك. للمزيد عن ذلك الكتاب وأحدث نشراته، انظر:Margaret Barker, The Lost Prophet, The Book of Enoch and Its Influence on Christianity, (Sheffield, 2005), 16-32; Joseph B. Lumpkin, The Books of Enoch, A Complete Volume Containing, 1 Enoch, 2 Enoch, 3 Enoch, (2010).
([19]) ابن النديم، الفهرست، 399-401. انظر أيضا:Werner Sundermann, “A Manichaean Collection of Letters and A List of Mani’s Letters in Middle Persian”, New Light on Manichaeism, ed. Jason David Beduhn (Leiden, 2009), 259-277.
([20]) Tardieu, Manichaeism, 41-43.
([21]) ترجم ليان جاردنر الكيفالايا إلى اللغة الإنجليزية سنة 1995م. انظر: Gardner, The Kephalaia of the Teacher, 10-294.
([22]) جيو وايد نغرين، ماني والمانوية: دراسة لديانة الزندقة وحياة مؤسسها، نقله إلى اللغة العربية سهيل زكار، (دمشق: دار حسان للطباعة والنشر، 1985)، 108-109.


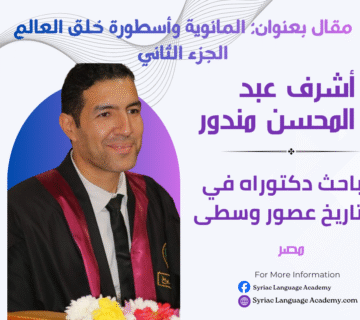
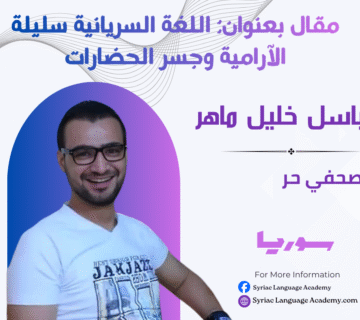
لا تعليق